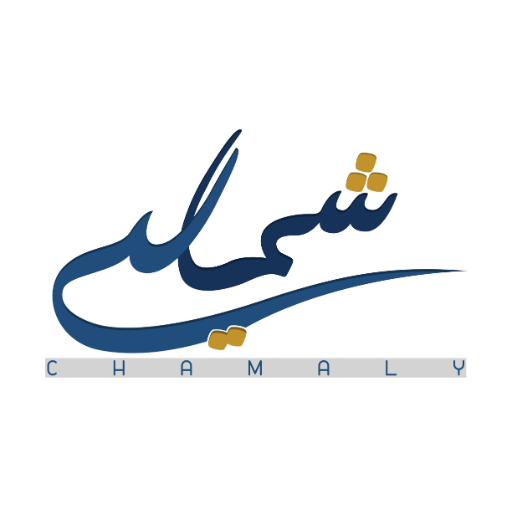طنجة الدولية المدينة المحاصرة
كيف ساهمت فرنسا وإسبانيا في الإفلاس الاقتصادي لطنجة
1912- 1956
د، محمد عزيز الطويل: باحث في التراث والحضارة
الكثير من أهالي طنجة يتغنى بما يسميه الفترة الذهبية لطنجة خلال فترة تدويلها، مع أن الحقيقة كانت غير ذلك، على الأقل بالنسبة لأهالي طنجة الذي امتهنوا مهنا بسيطة وبأجور منخفضة، وبدون تأمين صحي أو اجتماعي، وبشكل مماثل بالنسبة للجالية الإسبانية التي كانت تعيش الفقر والبؤس. الحقيقة أن مدينة طنجة لم تكن تمثل “إلدورادو”، كما يحلو للكثير تسميته، بل مثلت فضاء للفرص والتهريب والجاسوسية، وربما هذا ما كان يعوض طنجة كاقتصاد موازين وينعش جيوب المقيمين بها. وقد فرض على المدينة حصار اقتصادي فرنسي وإسباني، حيث كانت مدينة طنجة خاضعة للمساومات وتبادل المصالح، وإفشال متعمد لمختلف المبادرات التنموية بها.
فالمعروف أن مدينة طنجة تمتعت مع بداية القرن العشرين بوضعية خاصة، فبعدما شكلت المدينة عاصمة دبلوماسية للمغرب خلال القرن 19م، أصبحت مستقرا للأجانب من دبلوماسيين وتجار ومغامرين، وأرجعت هذه الوضعية الخاصة في جزء كبير منها، إلى الموقع الاستراتيجي للمدينة على مضيق جبل طارق، والقرب الجغرافي من أوربا، مما جعل القوى الأوربية تضع طنجة منذ القرن 19م في حساباتها الاستراتيجية، وتزايدت هذه الأهمية الاستراتيجية بعد فتح قناة السويس سنة 1869، حيث سيصبح مضيق جبل طارق ممرا تجاريا أساسيا لأروبا الغربية، ناهيك عن اعتبار المدينة بوابة رئيسية نحو المستعمرات الأوربية بإفريقيا، إضافة إلى النشاط الدبلوماسي المكثف بحكم أن المدينة أصبحت مقرا لمختلف التمثيليات القنصلية. وأمام هذه الأهمية نتساءل عن أسباب تخلف مدينة طنجة اقتصاديا خاصة خلال فترة تدويلها من سنة 1923 إلى 1956، رغم مؤهلاتها المتعددة الاستراتيجية والاقتصادية والضريبية.
وقد أصبحت مدينة طنجة خاضعة لنظام خاص تشرف عليه الهيئات الدبلوماسية المستقرة بالمدينة، فمنذ الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع الدول الطامعة في المغرب خاصة إيطاليا سنة 1902، ثم الاتفاقية الفرنسية البريطانية سنة 1904، ثم الاتفاق الودي مع إسبانيا سنة 1904، بشأن تحديد مناطق نفوذ الدولتين بشمال المغرب، ومع كل اتفاق كان يتم الإشارة إلى طنجة كمدينة ذات نظام خاص ، وخارج حسابات التقسيم الاستعماري، والحرص على إبقاء طنجة خارج الحسابات الاستعمارية، يرتبط بشكل وثيق بأهميتها في التحكم بمضيق جبل طارق. وتم تأكيد الوضع الخاص للمدينة مع معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906، كما تم ترسيم الوضع الخاص مع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، التي قسمت المغرب إلى ثلاث مناطق نفوذ استعماري، منطقة طنجة الدولية، ومنطقة الحمية الفرنسية، ثم منطقة الحماية الاسبانية، وفي جميع الأحوال تم التنصيص على خضوع هذه المناطق لسيادة السلطان المغربي. وبعد مفاوضات عسيرة امتدت على أكثر من 56 اجتماعا ما بين لندن وباريس، تم التوصل إلى الاتفاق على النظام الأساسي لتدويل مدينة طنجة بتاريخ 18 دجنبر 1923، حيث قام النظام الدولي على ثلاث مبادئ أساسية وهي: سيادة السلطان، والمساواة الاقتصادية، وحياد المنطقة الطنجية خلال أي نزاع عسكري ما بين الدول الأوربية. إلى جانب إنشاء مؤسسات دولية لتسيير المنطقة والمتمثلة في إدارة المنطقة، والمجلس التشريعي وهيئة المراقبة، بينما كان المندوب السلطاني يمثل السلطان بالمنطقة، رغم أنه كان خاضعا لمراقبة السلطات الفرنسية بحكم بنود الحماية الفرنسية.
لقد خلق هذا الوضع الدولي تناقضات متعددة، وهو ما شكل عيوبا حقيقية لنظام التدويل والحياد السياسي والعسكري ومبدأ التجارة الحرة، فإذا كان النظام الدولي بطنجة قد تأسس على أساس هذه المبادئ، فما هي أسباب عدم ازدهارها الاقتصادي خلال فترة التدويل.؟ وما مدى صحة المخيال الطنجي الذي يتحدث عن فترة ازدهار حقيقي خلال فترة التدويل؟. و يمكن أن نتحدث عن ازدهار، إذا قارنا ما بين طنجة ذات الطابع الأوربي خلال فترة التدويل، والتي تتمتع بمقومات الحياة البلدية من ماء وكهرباء وهاتف وطرق وقنوات الماء الشروب، وخطة لتصريف المياه العادمة وتنظيم الحياة البلدية بعدة قوانين. أما إذا قمنا بمقارنة مدينة طنجة مع المدن الأوربية فستكون النتيجة صفرية، وهو ما يؤكد فشل الازدهار الاقتصادي للمدن التي خضعت للتدويل. وفي جميع الأحوال أصبح ميناء طنجة منذ ثلاثينيات القرن 19م إلى بداية القرن العشرين، من أهم الموانئ المغربية رواجا، غير أن الاتفاقيات التي منحت طنجة وضعا خاصا، فرضت عزلة اقتصادية على مدينة طنجة، بفعل انتقال الرواج الاقتصادي إلى الموانئ الأطلنتية خاصة ميناء الدار البيضاء، ثم ميناء مدينة سبتة، حيث حرصت فرنسا وإسبانيا على تفضيل موانئها في أي تعامل تجاري، من وإلى المغرب. ويمكن إرجاع فشل التطوير الاقتصادي لمدينة طنجة خلال فترتها الدولية، إلى صعوبات تتعلق بنظام المراقبة الذي كانت تفرضه الإدارة الدولية، إلى جانب طبيعة النظام الجمركي، وفشل مشروع خط سكة حديد طنجة فاس، إلى جانب الفشل الذريع للمشاريع السياحية. فالحقيقة أن النفاذ إلى مدينة طنجة كان صعبا عبر البحر والبر بفعل إجراءات المراقبة الصارمة عبر البحر، وكذا تعدد الحواجز البرية التي أقامتها الحماية الفرنسية والإسبانية على حدود مناطق حمايتهما، وفرض جواز المرور إلى طنجة على المغاربة.
لقد جعل الموقع الاستراتيجي لميناء مدينة طنجة على مضيق جبل طارق وبين قارتين، وقربها الشديد من أوربا بمسافة لا تتعدى 14 كيلومتر، مختلف التقارير والمذكرات الاستعمارية منذ بداية القرن 20، تتنبأ بمستقبل واعد لميناء طنجة. هكذا شكل امتياز إنشاء ميناء مدينة طنجة صراعا إمبرياليا خاصة ما بين ألمانيا وفرنسا. وقد استغلت ألمانيا مقتل الصحفي الألماني “جينت Genthe” لتطالب المخزن المغربي بامتياز تنفيذ أشغال ميناء طنجة. وقد صرحت جريد “Le Figaro ” بتاريخ 16 يونيو 1905، بهذا الامتياز وسياقه، وسيبلغ طول الرصيف الذي ستبنيه الشركة الألمانية 330 مترا، وبتكلفة تصل إلى مليون ونصف مارك ألماني خلال عامين. رغم أن الاتفاق المغربي الألماني لم يحدد أي نوع من الضمانات الممنوحة للشركة الألمانية، أو نوع الإدارة التي ستتولى تنظيم بعمليات الشحن وتنظيم التجارة والملاحة.
وانطلاقا من سنة 1914 عهد إلى شركة دولية ببناء ميناء طنجة، وبالفعل أجرى مهندسو الشركة اختبارات الحفر بخليج طنجة على عمق عشرة أمتار، كما أرسلت الشركة مهندسين إلى نواحي أنجرة للبحث عن الصخور المناسبة لبناء الميناء. وانطلاقا من سنة 1921 منح المخزن المغربي مشروع بناء وتشغيل ميناء طنجة للشركة الدولية لتنمية طنجة، والتي أسستها شركة الأشغال العمومية المغربية سنة 1914. وبعد التوقيع على معاهدة تدويل طنجة سنة 1923، تم التأكيد خلالها على الظهير السلطاني لسنة 1921، بمنح الامتياز لشركة الأشغال العمومية المغربية. وبناء على معاهدة النظام الأساسي لتدويل طنجة لسنة 1923، وافق السلطان المغربي بتاريخ 22 مارس 1924 على شروط تعديل عقد امتياز ميناء طنجة، حيث تتيح هذه الموافقة فرصة لاستكمال وثائق المناقصة الدولية لأشغال الميناء. وبتاريخ 4 يوليوز 1924، نشرت اللجنة العامة للمناقصات والعقود التابعة للحكومة الشريفة إعلانًا عن مناقصة عامة لأشغال البنية التحتية في ميناء طنجة (كان مقرها في باريس)، حيث فازت الشركة الوطنية للأشغال العامة “SNTP” بتاريخ 18 دجنبر 1924.
انعكس تأخر تنفيذ اشغال ميناء طنجة من سنة 1904 إلى سنة 1924، على تطور المعاملات الملاحية والتجارية بميناء سبتة المحتل من طرف إسبانيا، فخلال هذه المدة وفر ميناء سبتة استضافة للسفن الكبيرة من خلال الرسو والتزود بالمؤن وإنزال البضائع، كما اجتذبت عدد كبيرا من المسافرين.
إلى جانب التحديات التي طرحها بناء ميناء طنجة، وتشديد الرقابة الأمنية على الوافدين، طرحت المعاملات الجمركية بدورها تحديات حقيقية، فإسبانيا اشتكت على الدوام من التمييز والاقصاء الممنهج لمصالحها التجارية بطنجة، من قبل مصلحة الجمارك بالمدينة التي كانت تعمل وفق التعليمات الفرنسية حسبها. وفي رد فعلها عمدت المندوبية السامية بتطوان إلى تشديد الخناق على الحدود البرية مع طنجة، فالرسوم الجمركية التي تحصلها جمارك طنجة على السلع الاسبانية الموجهة نحو منطقة الحماية الاسبانية سواء نحو تطوان أو العرائش أو أصيلة، كانت مرتفعة وينتظر تحويلها على إسبانيا، لهذا هددت إسبانيا انطلاقا من سنة 1925 بفرض رسوم جمركية مرتفعة بمختلف نقاطها الحدودية مع طنجة، وهو ما كان يعني تعرض البضائع لضريبة جمركية مزدوجة من شانها تعريض التجار للإفلاس، والسوق لخطر التضخم بفعل انعكاس الضريبة على ارتفاع الأسعار. وقد دفعت التهديدات الاسبانية بهيئة المراقبة بطنجة إلى الاحتجاج باسم “الوحدة الاقتصادية والجمركية بالمغرب”. لقد كانت المطالب الإسبانية تنادي بالحصول على 25% من الرسوم الجمركية لطنجة، وقد كان هذا الأمر يعني شيئا واحدا، وهو استحالة تحول مدينة طنجة إلى منطقة حرة بفعل الحسابات الاسبانية والفرنسية. خاصة وان إسبانيا كانت تعتقد بتعرضها للإقصاء في اتفاقية تدويل طنجة، لذا حرصت على إثارة العراقيل كلما سنحت لها الفرصة، بل تعمدت تحريض إيطاليا للمطالبة بتعديل النظام الأساسي لتدويل طنجة، وهو الأمر الذي حصل سنة 1928، بعدما أرفقت معاهدة التدويل لسنة 1923، ببروتوكول 1928.
بعد فرض عزل طنجة عبر البحر، تم التوجه نحو إقامة خط سكة حديدية يربط المدينة بالعمق المغربي ويضمن وصول البضائع والمسافرين من مختلف المناطق المغربية إلى طنجة وعبرها نحو أوربا. وبالفعل تولت الشركة الفرنسية الاسبانية لسكة حديد طنجة فاس المشروع سنة 1914، حيث ساهمت منطقتي الحماية الفرنسية والاسبانية إلى جانب طنجة في تكاليفه، وهو الأمر الذي احتجت عليه بريطانيا التي كانت حريصة على امتيازاتها الاقتصادية بالمغرب، حيث رأت أن مساهمة منطقة طنجة غير متناسبة مع حجمها الذي لا يتعدى 14 كيلومتر، مقارنة مع مناطق الحمايتين الفرنسية والاسبانية. غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى أوقف تنفيذ أشغال خط السكة الحديدية، حيث أصبحت الالتزامات المخولة للشركة بدون أي قيمة، وقد بينت مجلة “La Revue coloniale ” في عددها الصادر في يناير 1926، عن رغبة فرنسا في إنهاء تعهدها ببناء خط سكة حديد طنجة فاس. “يكفي إلقاء نظرة على خريطة المغرب لفهم المصلحة الكاملة لفرنسا في تأخير إنشاء خط سكة حديد من شأنه أن يضع أغنى مناطق المغرب، وعاصمة المغرب على بُعد ثلاث أو أربع ساعات من أوروبا، وأن يُنشئ، انطلاقًا من طنجة، وهي مدينة دولية، ميناءً كبيرًا قادرًا على احتكار الجزء الأكبر من حركة المرور الحالية في الدار البيضاء، والتي تُدار بالكامل تقريبًا في ساحات المعارض أو الموانئ سيئة التجهيز الواقعة على جانبي طنجة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى جزء كبير من الشحن الذي يُنقل عبر وهران إلى منطقة شرق المغرب الواقعة بين الحدود الجزائرية المغربية وفاس، وحتى مكناس، وجنوب هذه المدن بالكامل. طنجة، مدينة جميلة خلابة، قريبة من الجزيرة الخضراء، حيث ينتهي خط السكة الحديدية إلى باريس، كانت تتمتع بمزايا كثيرة لا تُمكنها من جمع عدد من العداوات ضدها. أولًا، طنجة، وهي مدينة أوروبية، ستكون منافسًا خطيرًا جدًا لجبل طارق، الذي ستُحيّده دون عناء. السيطرة على مضيق جبل طارق، بالنسبة لإنجلترا، مسألة حياة أو موت. إنه الطريق إلى مصر والهند، فتحه (من طنجة إلى فاس) سيجعل طنجة أكبر مدينة في المغرب ومينائها من أهم الموانئ في العالم. بالإضافة إلى التوفير في الوقت والمال المُحقق في نقل البضائع، فإن حركة المسافرين التي تُغذي اليوم جزءًا كبيرًا من تجارة الدار البيضاء ستُثري طنجة وتزيد من سكانها الثابتين والمتنقلين.”. لقد كان الأمر واضحا بالنسبة لفرنسا إقامة خط سكة حديد فاس طنجة كان يعني شيئا واحدا: كساد موانئها الأطلنتية بحمايتها بالمغرب، وبمستعمراتها الجزائرية، بل إن إنشاء هذا الخط يعتبر تهديدا لإنجلترا كذلك. وقد صدرت تقارير عديدة بشأن الحالة المتردية للحركة التجارية سواء بميناء طنجة أو بخط السكة الحديدية، فقد أشارت غرفة التجارة الدولية بطنجة سنة 1932 إلى انعدام الرواج التجاري بطنجة، حيث أوضحت أن الأمر يرتبط بعدة صعوبات فرضتها مناطق المراقبة الحدودية للحمايتين الفرنسية والاسبانية مع مدينة طنجة، إلى جانب فرض تعريفة باهضة حيث تحول خط السكة الحديدية طنجة فاس إلى أغلى خط سكة في المغرب، كما أدى رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة عبر طنجة. إلى تحويل البضائع نحو ميناء العرائش أو الدار البيضاء. كما أدى الكساد الكبير للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 في تعميق جراح طنجة اقتصاديا.
أمام فشل ميناء طنجة وخط سكة حديد فاس طنجة في ربط المدينة بعمقها المغربي، وفي تحقيق ترابط حقيقي مع أوربا من خلال تحول طنجة إلى مدينة حرة اقتصاديا، لم يبقى سوى التنمية السياحية، لتعويض الكساد الممنهج والمفروض على طنجة من قبل فرنسا وإسبانيا. حيث تم التعويل على جمالية طنجة وحسن تنظيمها ونظافتها وتنوع أماكنها السياحية، وعلى تنظيم المهرجانات والمسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية المختلفة، كعناصر جذب سياحي، لكن هاته العناصر لم تكن كافية لجذب أغنياء أوربا الذين ينفقون بسخاء، فتم اقتراح إنشاء الكازينو المحتضن لألعاب القمار. لكن هذا الاقتراح لقي معارضة شديدة من إسبانيا، وهو ما دفع الإدارة الدولية إلى محاصرة مختلف ألعاب القمار سواء بالفنادق أو المقاهي. وابتداء من سنة 1938 ، اقترحت الإدارة الدولية بطنجة سن قانون احتكار المقامرة، لكنه لقي معارضة شديدة كذلك حيث كانت المقامرة محرمة في إسبانيا، ورغم أن طنجة لم تكن مدينة إسبانية، إلا أن اسبانيا تحججت بارتفاع عدد مواطنيها بالمدينة، وحرصها على “الحفاظ على القيم الأخلاقية للمستعمرة الإسبانية…. والنزاهة والاجتهاد”. ولم تزدهر السياحة بطنجة إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945، حيث سجلت طنجة ارتفاعا كبيرا في السياح الوافدين عليها، لكنها في جميع الأحوال لم تستفد، حيث كان يتم توجيه العائدات المالية لسداد قروض المغرب، وتوفير السيولة المالية لاستثمارها في أشغال الميناء وسكة حديد طنجة فاس.
دفعت الوضعية المتردية لطنجة بمختلف الشرائح الاجتماعية إلى الاحتجاج، حيث وجه أهالي طنجة سنة 1952 عريضة إلى إدارة المنطقة، تضمنت تنديدا بالحواجز الجمركية التي تفرضها إسبانيا وفرنسا على طنجة، وبقلة المال والعمل والغلاء وانتشاء الرذيلة. كما يشير احد المستثمرين الإسبان إلى الحالة المتردية للجالية الإسبانية بطنجة التي تعتبر الأكثر فقرا وبؤسا “تحاول العديد من القوى سلب طنجة موارد عيشها، وتقويض نموها التجاري لصالح ميناء الدار البيضاء والقنيطرة وسبتة والعرائش وجبل طارق”، كما نددت عرائض أخرى وقعها تجار من جنسيات مختلفة، بالهجوم على اقتصاد طنجة ومنع ازدهارها التجاري، خاصة من خلال فرض ضرائب مرتفعة، وعدم التحكم في غلاء المواد الغذائية. وتقترح مختلف العرائض والشكاوى العديد من الحلول للخنق والحصار الاقتصادي لطنجة، من خلال تخفيض تسعيرة خط سكة حديد طنجة فاس، وتخفيف إجراءات الرقابة الأمنية، وتأسيس المنطقة الحرة. بل إن البعض كان يرى في النظام الدولي سبب المشاكل كلها ، لذا طلبت بربط طنجة بباقي أجزاء المغرب، ولعل هذا المقترح كان ينبع من السلطات الفرنسية التي كانت تريد الهيمنة على طنجة وضمها إلى منطقة حمايتها. أما الجالية الإسبانية اقترحت تأسيس تجارة حرة مع المنطقة الاسبانية.
لكن قدر طنجة خلال فترة تدويلها، كان ما بين المطرقة والسندان، مطرقة المصالح الفرنسية التي كانت ترى في نمو المعاملات التجارية بميناء طنجة، تهديدا لموانئها بالساحل الأطلنتي خاصة ميناء ليوطي، كما أن نجاح خط سكة حديد طنجة فاس، كان يعني إفلاس شركات النقل والشحن الفرنسية، اما سندان المصالح الإسبانية فكان يقول بكل وضوح ان القوى الاستعمارية مخيرة بين أمرين، إما ضم طنجة إلى منطقة الحماية الفرنسية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، او عزلها عزلة تامة، وهطا ما حصل، بعد التقاء المصالح الفرنسية والإسبانية. لكن المدينة بحكم مؤهلاتها الاستراتيجية كانت على موعد، مع التنمية الاقتصادية خلال العهد الجديد. عهد جلالة الملك محمد السادس الذي حول طنجة إلى أكبر قطب مينائي عالمي، ومركزا عالميا لصناعة السيارات، وإقامة سياحية دائمة.